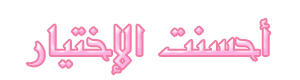محمد شتيوى
مستشار سابق
كيف نقرأ ؟!

بقلم إبراهيم العسعس
في إحدى القرى ...
طرَق "ساعي البريد" الباب، خرج الأبُ، فسلَّمهُ الساعي رسالةً، وقال: إنَّها لابنتـك!
لم يكن الأب يعرفُ القراءة، وبدأ الفأرُ يلعب بِعبه ـ كما يقال في العامية ـ، مِن أين أتت الرسالة؟ وهل تكون البنت ...؟! وما مضمونها؟ خرج مسرعاً إلى الطريق لعلَّه يجد مَن يقرأ له الرسالة لتطمئنَّ نفسُه.
وجد مُعلمةَ المدرسة في الطريق، فقال هذا هو المطلوب، أتقرئين لي هذه الرسالة التي وصلت لابنتي؟ سأل الأبُ ... بالطبع، أجابت المعلمةُ، فضَّت الرسالةَ وبدأت بالقراءة ... قرأت له رسالةَ غزلٍ موجهةً لابنته من أحدهم! حَمل الأبُ الرسالةَ ومضى غاضباً، في الطريق لقي ابنَ صاحبِ البيت الذي يسكن فيه، فطلب منه أن يقرأ له الرسالة، يريد أن يتأكد!
فقرأ الشاب، فإذا هي رجاءٌ من صاحب البيت للبنت أن تُذكِّر أباها بضرورة دفعِ أُجرة البيت المُتراكمة عليه، عارضاً لها سوءَ الأحوال، وضيقَ ذات اليد! ما هذا أصبح عندنا قراءتان لرسالةٍ واحدة! صاحَ الأبُ، فما هي حقيقة الرسالة؟! لا بدُّ من ثالث ليُبيِّنَ لي ما في الرسالة.
فإذا بأحد الشباب الذي ينتظرُ فرصتَه للعمل أو السفر، أعطاهُ الرسالة بعد أن شرحَ له الحال، قرأ الشاب، فتحدَّث عن صعوبة العيش في القرية، وقِـلِّة فُرص العمل، وأنَّ من يُهاجر يجد فرصته في بلاد الخواجات ! شـدَّ الرجلُ شعرَ رأسه، وصرخ: ولكن، أين هي الحقيقة؟! فلم يسمع إلاَّ صدى صوته، مع ضحكات من حوله من قُـرَّاء الرسالة !! لقد رأى كلُّ منهم في الرسالة ما يُحبُّ أن يرى، وما في نفسه، لا ما هو موجود فيها فعلاً ! لقد انعكست آمـالُ كلٍّ منهم، ورغباته، وطبائعه على الرسالة فلم يعُـد يرى غيرها ! وهكذا ضاعت الحقيقة بين هذه الآمال والرغبات والطبائع .
******
الحقيقة الضائعة:
إنها قصة تقع، وإن لم يكن بحرفية هذه القصة، إذ إنَّ جانب الرمزية والمبالغة الدرامية واضح فيها! وهذا كلُّه غير مهم، فالذي يعنينا الفكرة العميقة والخطيرة التي أرادت القصة توصيلها . إنَّها تتحدث عن الحقيقة الضائعة عندما تتحول القراءة إلى حوار مع النفس، يقرأ من خلالها القارئ ما في نفسه لا ما هو مكتوب! وفي هذه الحالة تفقدُ القراءةُ قيمتَها وغايتها، فالكلمة هنا لا دلالة محددة لها، لأنَّه بمثـل هذه القراءة تصبح دلالة الكلمة لا نهاية لها، إذ يُمكن أن تكون دلالاتها بعدد ما على البسيطة من قُرَّاء!
ومع الأسف الشديد هذه القراءة هي قراءتنا! وليس فقط أننا لا نقرأ! بل عندما نقرأ، نقرأ قراءة خاطئة! مُسيَّـرة! قراءة أميَّة!!
قراءة أمِيَّة؟!:
وكأنها جملة ينقضُ آخرُها أولَها! فكيف تكون قراءةً، وأميَّةً في الوقت نفسه؟! إنها لكذلك عندما تكون القراءة مُجرد "فكِّ" الحرف دون فهم! وبلا ربط بين أول الكلام وآخره! وبين الكلمة في مكان وغيرها من الكلمات في مكان آخر! وبين قراءة الكلمة وقراءة الكون، أو قراءة الواقع! هذه القراءة سمَّاها القرآن الحكيم: أُميَّةً! وعدَّ الذين يقرؤونها: أُميُّون!: " ومنهم أميُّون لا يعلمونَ الكتابَ إلاَّ أمانيَّ، وإنْ هم إلاَّ يظنُّون" (البقرة: 78 ) . الأماني هي القراءة بلا وعي، ولذلك قال "لا يعلمون"، ولم يقل لا يقرؤون! فالقرآن يعدُّ الوقوف عند مستوى قراءة الحروف ضرباً من الأميَّة.
فكيف نقرأ؟
سأذكر ما نحن عليه، وما ينبغي أن نكون عليه في سياق واحد اختصاراً، وتحقيقاً للفائدة المرجوَّة في مقالة مضغوطة، فالقضية التي نتحدث عنها كثيرة الذيول، عميقة الأبعاد، تحتـاج لكتاب مُسترسِل !
- هل نقرأ باسم الله؟! لا تتسرع في الإجابة وتقول: بدأ الشيخ يُخلِّط! فكلنا نبدأ قراءتنا باسم الله! وأنا أقول، وهو كذلك، فنحن قبل أن نقرأ نبدأ باسم الله، وقد يأخذ منا الثناء على الله، والحمد له سبحانه صفحات، فهل هذا هو الذي طلبه الله تعالى في أول كلمة نزلت في آخر رسالة؟! "اقرأ باسم ربك الذي خلق".
إنَّ أبعاد القراءة باسم الله كَسَعَة هذا الكون، حسبنا منها الإشارة إلى ما نحن بصدده، أعني القراءة التي تُحقِّـق هدفها. إنَّها استحضار رقابة الله حذراً من الوقوع في الطغيان؛ الطغيانِ في الفهم، فحمل النفس على الفهم تكليف. الطغيان في الدخول على النَّص وقد قررنا ما نريدُه مما لا نريده قبل أن نقرأ حرفاً! إنها باسم الله التي تقينا هذه المصارع. وكما بينت لنا النصوص أنَّ القراءة بلا علم ضلال، بينت لنا أنَّ القراءة دون باسم الله طغيان.
القراءة الذرية
وهذه القراءة تُفكِّكُ النص، بل وتُفكِّكُ الجملة، وأكاد أقول: بل وتـُفككُ الكلمة! إنَّها تغوص في الكلمة وتعزلها عما حولها، ثم تخرج منها لتدخل فيما بعدها دون أيِّ رابطٍ بينهما! إنَّها قراءة "تُقصقِصُ" النَّصَّ وتفهم ـ هذا إنْ فهمت ـ كلَّ جملة، أو كلَّ كلمة بعيداً عن سياقها، ولذلك فإنها تبني على كلِّ كلمة قراراً وقضية جديدة لا علاقة لها بقضية النص الواحدة، بمعنى أنها تمتصُّ ـ ولا أقول تفهم أو تستـنتج! لأنَّ صاحب هذه القراءة يتفاعل مع النص تفاعلاً غريزياً فلا يستطيع أن يفهم! ـ من كلِّ كلمة، أو جملة قضية منفصلة! إنَّ النص في هذه القراءة يتكون من مجموعة من الجزر المنعزلة عن بعضها!
يقابل هذه القراءة، القراءة الإحاطية الشمولية، التي تستعرض النصَّ كلَّه، لتفهم عليه ما يريد. وصاحبُ هذه القراءة يُدرك أنَّ أيَّ استبعاد لأيةِ كلمة ـ قصداً أو سهواً ـ سينتهي إلى نتائج لم يُردها النصُّ، وأنَّ الفرق بين وجود حرف وعدم وجوده تـترتب عليه قضية هائلة رهيبة، قد تكون كالفرق بين الكفر والإيمان، كما حصل في سورة (الكافرون)!
إنَّ سوء الفهم يعود إلى أنَّ القارئ يتناولُ النص، أو ينظر إليه من زاوية معينة لا إحاطة فيها، ولو سعى القارئ إلى امتلاك مهارة القراءة الشمولية، وتناولَ النَّصَّ من مُختلف الزوايا لَبنى فيما بينه وبين الكاتب جسراً متيناً من التواصل والتفاهم.
القراءة العصافيرية
وأعني بها القراءة التي لا تَراكُم فيها. فصاحبُ هذه القراءة لا يبني شيئاً، يعيش مع النصِّ في لحظة زمنية مُجمَّـدة، وقد يستمتع بقراءته، وقد يبكي ويضحك، ثم بعد ذلك كأنَّه لم يقرأ شيئاً ! فذاكرته مخرومة، مُستباحة، لا تُمسك ماءً ولا تُنْبِتُ كلأً. قُدرته على الاستحضار معدومة، والأمر عنده أُنُف، دائماً يبدأ من جديد، فهو بالضبط كالعصفور الذي لا تاريخ له، يقع في نفس الفخِّ الذي وقع فيه قبل قليل! فكيف تـتوقع أن يبنيَ هذا النَّمطُ حواراً مع النص بقصد الوصول إلى الفائدة والتفاعل؟!
- يقابل هذه القراءة، القراءة التراكُميَّة، وهي قراءة تـبني على ما سبق، وتربط اللاحق بالسابق، لِـتكوِّنَ من بعـدُ مجموعةً من الأفكار والفوائد المتراكمة، بها يستطيع القارئ أنْ يَلِـجَ إلى النصِّ ليفهم عنه ويتـفاعل معه.
القراءة الغرائزية
ولئن سألتَ صاحبَ هذه القراءة، لماذا تقرأ؟ لقال لك: أنا أقـرأ لأنـَّني أعرف القراءة! وأمتلك كُتباً! وعندي حاسوب! وأزيدك: أنا رابط "انترنت"!!! فلماذا لا أقرأ؟! فهل يستطيع هذا القارئ أن يفهم النص، ويتـفاعل معه؟! إنَّ القارئ الغرائزي ينظر إلى النصِّ ولا يُبصره!! نظر المغشيِّ عليه من الموت!! ويُفكك حروفه تلقائياً دون أنْ تدخل هذه القراءة إلى برنامجه الذهني، ومواقـفه من النَّصِّ ـ رفضاً أو موافقةً ـ مواقف غرائزية لا عقل فيها، فهي ردَّات أفعال، وسوانح خواطر، وليست مما يقتضيه العقل والفكر! فمن الذي يقابل القارئ الغرائزي؟! إنه القارئ الواعي المريد، الذي يستقبل النص استقبالاً مقصوداً، عقله معه، وذهنه حاضر. يعرف لماذا يقرأ، ويعرف ماذا يقرأ، ويعرف كيف يقرأ. القراءة بالنسبة له نورٌ يمشي به يضيء له الطريق، ويحس معها بالدهشة التي يشعر بها من يطلع على المعرفة.
إشكالية التَّحيز
من أخطر ما يُعطِّل قيمة القراءة، ويُفقدها غايتها، أن يدخل القارئ على النص وهو مُتحيِّز إلى عاطفة، أو فكرة مسبقة! فإذا فعل ذلك تـشوَّش معيار التقويم، وضلَّ مقياس الموضوعية! ولا يخفى على المراقب أن قراءتنا ـ على الأغلب ـ متحيزة عاطفياً، وفكرياً، فنحن نحب أن نقرأ ما يدغدغ عواطفنا وإن خالف الحقيقة، ونأخذ موقفاً مسبقاً ممن نعرف أنه يخالفنا، أو يطرح ما يزعجنا!
وهذا يعني أن معيارنا في القراءة أهواؤنا، ورغباتنا، ومقرراتنا المسبقة، فمن وافقها فهو الذي لم تلد النساء مثله! ومن الأمثلة على ذلك، قضية السلبية والإيجابية، فما هو مقياس السلبية والإيجابية عندنا؟ إنه ما نحب وما لا نحب! فإن قرأنا ما نتبنى، ونحب فالكاتب إيجابي، وإلا فهو سلبي مُثبِّط! ومثل ذلك التـفاؤل والتشاؤم، مقياسهما لدينا مطاط جداً، حمَّال وجوه، والحكم في النهاية أهواؤنا ورغباتنا!
إنَّ القراءة المقابلة لهذه الآفة هي القراءة المحايدة، وأستدركُ لأقول قدر الإمكان! لأنني أدرك أن الحياد المطلق غير مقدور عليه، لكن نُسدِّد ونقارب إلى الدرجة التي تكون فيها القراءة أقربَ ما يكون إلى الحياد، وأبعدَ ما يكون عن المقررات السابقة. إنَّ القراءة المحايدة قراءة تحب الحقيقة ولو أزعجتها، وتقبل الحق ولو كان من أبغض الناس، بل ولو كان من أفسق الناس، كما كان يقول أحد الكبار :
" إعمل بعلمي ولا يمنعك تقصيري ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري "
والقراءة المحايدة موضوعية، تحتكم إلى المعلومة التي تـنـقل الواقع كما هو، وتعرض الحقيقة كما ينبغي لا كما تحب .
وأخـيـراً القراءة المتسرعة
وأعني بها القراءة التي تأخذ موقفاً بادي الرأي، تخطف الكلمة أو الجملة خطفاً، ثم تبني عليه قصراً من وجهات النظر المتعجلة. ومن قرأ هذه القراءة فحتماً سينـقطع التواصل والتفاهم بينه وبين الكاتب، وسيحمل كلَّ ما يقرأ حملاً لا إنصاف فيه، وسيُوظِّف كلَّ ما يعرفه من آليات التعامل مع النصوص ليدعم وجهة نظره المتسرعة، فيشرع باصطياد الثغرات ـ أو ما يظن أنها ثغرات!! ـ ليُرديَ الكاتب أرضاً، ويحمل المحتمل على الصريح، وينادي على رؤوس الأشهاد ملوِّحاً بالمحتمل: أنْ هذا هو كاتبكم العظيم فاحذروه! ويقابل هذه القراءة، القراءة المتأنية المُنصفة، التي لا تستعجل النتائج، وتعطي الكاتب الفرصة التي يستحقها للفهم عنه، وتحمل محتمله على صريحة، وتستخدم آليات فهم النص لخدمة الوصول إلى الحقيقة.
وأخيراً، وتلخيصاً
إنَّ القراءة المطلوبة هي القراءة المبنية على الإخلاص والإنصاف والفهم والوعي والتدبر، القراءة التي تربط وتستنتج.
إن بداية النهضة هي قراءة صحيحة، ولا يمكن أن ينجح شعار الـتوحيد أولاً دون هذه القراءة. فلا عجب أن كانت هذه الكلمة أول كلمة في آخر رسالة. هذه الكلمة التي لا أجد في وصف عظمتها وخطورتها أبلغ مما قاله سيد رحمه الله فيها: "الكلمة التي أدهشت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثارت معه وعليه العالم". فلله درُّ سيد رحمة الله عليه. وكيف لا وهي التي وضعها القرآن بداية للذين حمَّلهم مسؤولية تغيير العالم، وقيادة البشرية، وقد سُئل فولتير مرةً عمَّن سيقود العالم، فأجاب: "الذين يعرفون كيف يقرؤون".
وها هي المطابع في العالم الإسلامي، تدفع في كل عام آلافاً من الكتب، وها هي الشواهد تدل على أن الذي يقود العالم هم الذين يحسنون القراءة، ونحن لا زلنا قابعين على حدود القراءة الأمية، العصافيرية، الخ.. القائمة القاتمة ! إننا نمتلك وسيلة الحضارة، ومنهج التقدم ؛ القرآن، ومع ذلك فإن حالة الوهن التي نعيشها تحرمنا من الإفادة من هذا الكتاب الحكيم.
إن حوارنا حوار طرشان، والتواصل فيما بيننا معدوم، ولقد يصدق علينا ما قاله حسن البنا رحمه الله: "إذا شرحت فكرتك لأحدهم عشرين مرة، ثم ظننت أنه قد فهمك فأنت متفائل"!
وأختم بهذا الحديث الرائع الذي يصف عجزنا عن القراءة المنتجة، وكيف أن القراءة المطلوبة ليست هي مجرد قراءة الأحرف، فقد روى زياد بن لبيد، فقال: " ذكرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلـم شيئاً، فقال: "وذاك عند ذهابِ العلم، قُلنا يا رسولَ الله : وكيف يذهبُ العلمُ؟ ونحنُ قرأنا القرآنَ ونُقرئه أبناءَنا، وأبناؤنا يُقرؤون أبناءهم، فقال: "ثَكِلتْكَ أمُّكَ يا ابنَ لبيد،إنْ كنتُ لأراكَ من أفـقهِ رجلٍ بالمدينة، أوَ ليس هذه اليهودُ والنصارى يقرءونَ التوراةَ والإنجيل، ولا ينتفعونَ ممَّا فيهما بشيءٍ؟!"، رواه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح.
______________________________
المصدر : مجلة العصر - الثقافة والأدب .

بقلم إبراهيم العسعس
في إحدى القرى ...
طرَق "ساعي البريد" الباب، خرج الأبُ، فسلَّمهُ الساعي رسالةً، وقال: إنَّها لابنتـك!
لم يكن الأب يعرفُ القراءة، وبدأ الفأرُ يلعب بِعبه ـ كما يقال في العامية ـ، مِن أين أتت الرسالة؟ وهل تكون البنت ...؟! وما مضمونها؟ خرج مسرعاً إلى الطريق لعلَّه يجد مَن يقرأ له الرسالة لتطمئنَّ نفسُه.
وجد مُعلمةَ المدرسة في الطريق، فقال هذا هو المطلوب، أتقرئين لي هذه الرسالة التي وصلت لابنتي؟ سأل الأبُ ... بالطبع، أجابت المعلمةُ، فضَّت الرسالةَ وبدأت بالقراءة ... قرأت له رسالةَ غزلٍ موجهةً لابنته من أحدهم! حَمل الأبُ الرسالةَ ومضى غاضباً، في الطريق لقي ابنَ صاحبِ البيت الذي يسكن فيه، فطلب منه أن يقرأ له الرسالة، يريد أن يتأكد!
فقرأ الشاب، فإذا هي رجاءٌ من صاحب البيت للبنت أن تُذكِّر أباها بضرورة دفعِ أُجرة البيت المُتراكمة عليه، عارضاً لها سوءَ الأحوال، وضيقَ ذات اليد! ما هذا أصبح عندنا قراءتان لرسالةٍ واحدة! صاحَ الأبُ، فما هي حقيقة الرسالة؟! لا بدُّ من ثالث ليُبيِّنَ لي ما في الرسالة.
فإذا بأحد الشباب الذي ينتظرُ فرصتَه للعمل أو السفر، أعطاهُ الرسالة بعد أن شرحَ له الحال، قرأ الشاب، فتحدَّث عن صعوبة العيش في القرية، وقِـلِّة فُرص العمل، وأنَّ من يُهاجر يجد فرصته في بلاد الخواجات ! شـدَّ الرجلُ شعرَ رأسه، وصرخ: ولكن، أين هي الحقيقة؟! فلم يسمع إلاَّ صدى صوته، مع ضحكات من حوله من قُـرَّاء الرسالة !! لقد رأى كلُّ منهم في الرسالة ما يُحبُّ أن يرى، وما في نفسه، لا ما هو موجود فيها فعلاً ! لقد انعكست آمـالُ كلٍّ منهم، ورغباته، وطبائعه على الرسالة فلم يعُـد يرى غيرها ! وهكذا ضاعت الحقيقة بين هذه الآمال والرغبات والطبائع .
******
الحقيقة الضائعة:
إنها قصة تقع، وإن لم يكن بحرفية هذه القصة، إذ إنَّ جانب الرمزية والمبالغة الدرامية واضح فيها! وهذا كلُّه غير مهم، فالذي يعنينا الفكرة العميقة والخطيرة التي أرادت القصة توصيلها . إنَّها تتحدث عن الحقيقة الضائعة عندما تتحول القراءة إلى حوار مع النفس، يقرأ من خلالها القارئ ما في نفسه لا ما هو مكتوب! وفي هذه الحالة تفقدُ القراءةُ قيمتَها وغايتها، فالكلمة هنا لا دلالة محددة لها، لأنَّه بمثـل هذه القراءة تصبح دلالة الكلمة لا نهاية لها، إذ يُمكن أن تكون دلالاتها بعدد ما على البسيطة من قُرَّاء!
ومع الأسف الشديد هذه القراءة هي قراءتنا! وليس فقط أننا لا نقرأ! بل عندما نقرأ، نقرأ قراءة خاطئة! مُسيَّـرة! قراءة أميَّة!!
قراءة أمِيَّة؟!:
وكأنها جملة ينقضُ آخرُها أولَها! فكيف تكون قراءةً، وأميَّةً في الوقت نفسه؟! إنها لكذلك عندما تكون القراءة مُجرد "فكِّ" الحرف دون فهم! وبلا ربط بين أول الكلام وآخره! وبين الكلمة في مكان وغيرها من الكلمات في مكان آخر! وبين قراءة الكلمة وقراءة الكون، أو قراءة الواقع! هذه القراءة سمَّاها القرآن الحكيم: أُميَّةً! وعدَّ الذين يقرؤونها: أُميُّون!: " ومنهم أميُّون لا يعلمونَ الكتابَ إلاَّ أمانيَّ، وإنْ هم إلاَّ يظنُّون" (البقرة: 78 ) . الأماني هي القراءة بلا وعي، ولذلك قال "لا يعلمون"، ولم يقل لا يقرؤون! فالقرآن يعدُّ الوقوف عند مستوى قراءة الحروف ضرباً من الأميَّة.
فكيف نقرأ؟
سأذكر ما نحن عليه، وما ينبغي أن نكون عليه في سياق واحد اختصاراً، وتحقيقاً للفائدة المرجوَّة في مقالة مضغوطة، فالقضية التي نتحدث عنها كثيرة الذيول، عميقة الأبعاد، تحتـاج لكتاب مُسترسِل !
- هل نقرأ باسم الله؟! لا تتسرع في الإجابة وتقول: بدأ الشيخ يُخلِّط! فكلنا نبدأ قراءتنا باسم الله! وأنا أقول، وهو كذلك، فنحن قبل أن نقرأ نبدأ باسم الله، وقد يأخذ منا الثناء على الله، والحمد له سبحانه صفحات، فهل هذا هو الذي طلبه الله تعالى في أول كلمة نزلت في آخر رسالة؟! "اقرأ باسم ربك الذي خلق".
إنَّ أبعاد القراءة باسم الله كَسَعَة هذا الكون، حسبنا منها الإشارة إلى ما نحن بصدده، أعني القراءة التي تُحقِّـق هدفها. إنَّها استحضار رقابة الله حذراً من الوقوع في الطغيان؛ الطغيانِ في الفهم، فحمل النفس على الفهم تكليف. الطغيان في الدخول على النَّص وقد قررنا ما نريدُه مما لا نريده قبل أن نقرأ حرفاً! إنها باسم الله التي تقينا هذه المصارع. وكما بينت لنا النصوص أنَّ القراءة بلا علم ضلال، بينت لنا أنَّ القراءة دون باسم الله طغيان.
القراءة الذرية
وهذه القراءة تُفكِّكُ النص، بل وتُفكِّكُ الجملة، وأكاد أقول: بل وتـُفككُ الكلمة! إنَّها تغوص في الكلمة وتعزلها عما حولها، ثم تخرج منها لتدخل فيما بعدها دون أيِّ رابطٍ بينهما! إنَّها قراءة "تُقصقِصُ" النَّصَّ وتفهم ـ هذا إنْ فهمت ـ كلَّ جملة، أو كلَّ كلمة بعيداً عن سياقها، ولذلك فإنها تبني على كلِّ كلمة قراراً وقضية جديدة لا علاقة لها بقضية النص الواحدة، بمعنى أنها تمتصُّ ـ ولا أقول تفهم أو تستـنتج! لأنَّ صاحب هذه القراءة يتفاعل مع النص تفاعلاً غريزياً فلا يستطيع أن يفهم! ـ من كلِّ كلمة، أو جملة قضية منفصلة! إنَّ النص في هذه القراءة يتكون من مجموعة من الجزر المنعزلة عن بعضها!
يقابل هذه القراءة، القراءة الإحاطية الشمولية، التي تستعرض النصَّ كلَّه، لتفهم عليه ما يريد. وصاحبُ هذه القراءة يُدرك أنَّ أيَّ استبعاد لأيةِ كلمة ـ قصداً أو سهواً ـ سينتهي إلى نتائج لم يُردها النصُّ، وأنَّ الفرق بين وجود حرف وعدم وجوده تـترتب عليه قضية هائلة رهيبة، قد تكون كالفرق بين الكفر والإيمان، كما حصل في سورة (الكافرون)!
إنَّ سوء الفهم يعود إلى أنَّ القارئ يتناولُ النص، أو ينظر إليه من زاوية معينة لا إحاطة فيها، ولو سعى القارئ إلى امتلاك مهارة القراءة الشمولية، وتناولَ النَّصَّ من مُختلف الزوايا لَبنى فيما بينه وبين الكاتب جسراً متيناً من التواصل والتفاهم.
القراءة العصافيرية
وأعني بها القراءة التي لا تَراكُم فيها. فصاحبُ هذه القراءة لا يبني شيئاً، يعيش مع النصِّ في لحظة زمنية مُجمَّـدة، وقد يستمتع بقراءته، وقد يبكي ويضحك، ثم بعد ذلك كأنَّه لم يقرأ شيئاً ! فذاكرته مخرومة، مُستباحة، لا تُمسك ماءً ولا تُنْبِتُ كلأً. قُدرته على الاستحضار معدومة، والأمر عنده أُنُف، دائماً يبدأ من جديد، فهو بالضبط كالعصفور الذي لا تاريخ له، يقع في نفس الفخِّ الذي وقع فيه قبل قليل! فكيف تـتوقع أن يبنيَ هذا النَّمطُ حواراً مع النص بقصد الوصول إلى الفائدة والتفاعل؟!
- يقابل هذه القراءة، القراءة التراكُميَّة، وهي قراءة تـبني على ما سبق، وتربط اللاحق بالسابق، لِـتكوِّنَ من بعـدُ مجموعةً من الأفكار والفوائد المتراكمة، بها يستطيع القارئ أنْ يَلِـجَ إلى النصِّ ليفهم عنه ويتـفاعل معه.
القراءة الغرائزية
ولئن سألتَ صاحبَ هذه القراءة، لماذا تقرأ؟ لقال لك: أنا أقـرأ لأنـَّني أعرف القراءة! وأمتلك كُتباً! وعندي حاسوب! وأزيدك: أنا رابط "انترنت"!!! فلماذا لا أقرأ؟! فهل يستطيع هذا القارئ أن يفهم النص، ويتـفاعل معه؟! إنَّ القارئ الغرائزي ينظر إلى النصِّ ولا يُبصره!! نظر المغشيِّ عليه من الموت!! ويُفكك حروفه تلقائياً دون أنْ تدخل هذه القراءة إلى برنامجه الذهني، ومواقـفه من النَّصِّ ـ رفضاً أو موافقةً ـ مواقف غرائزية لا عقل فيها، فهي ردَّات أفعال، وسوانح خواطر، وليست مما يقتضيه العقل والفكر! فمن الذي يقابل القارئ الغرائزي؟! إنه القارئ الواعي المريد، الذي يستقبل النص استقبالاً مقصوداً، عقله معه، وذهنه حاضر. يعرف لماذا يقرأ، ويعرف ماذا يقرأ، ويعرف كيف يقرأ. القراءة بالنسبة له نورٌ يمشي به يضيء له الطريق، ويحس معها بالدهشة التي يشعر بها من يطلع على المعرفة.
إشكالية التَّحيز
من أخطر ما يُعطِّل قيمة القراءة، ويُفقدها غايتها، أن يدخل القارئ على النص وهو مُتحيِّز إلى عاطفة، أو فكرة مسبقة! فإذا فعل ذلك تـشوَّش معيار التقويم، وضلَّ مقياس الموضوعية! ولا يخفى على المراقب أن قراءتنا ـ على الأغلب ـ متحيزة عاطفياً، وفكرياً، فنحن نحب أن نقرأ ما يدغدغ عواطفنا وإن خالف الحقيقة، ونأخذ موقفاً مسبقاً ممن نعرف أنه يخالفنا، أو يطرح ما يزعجنا!
وهذا يعني أن معيارنا في القراءة أهواؤنا، ورغباتنا، ومقرراتنا المسبقة، فمن وافقها فهو الذي لم تلد النساء مثله! ومن الأمثلة على ذلك، قضية السلبية والإيجابية، فما هو مقياس السلبية والإيجابية عندنا؟ إنه ما نحب وما لا نحب! فإن قرأنا ما نتبنى، ونحب فالكاتب إيجابي، وإلا فهو سلبي مُثبِّط! ومثل ذلك التـفاؤل والتشاؤم، مقياسهما لدينا مطاط جداً، حمَّال وجوه، والحكم في النهاية أهواؤنا ورغباتنا!
إنَّ القراءة المقابلة لهذه الآفة هي القراءة المحايدة، وأستدركُ لأقول قدر الإمكان! لأنني أدرك أن الحياد المطلق غير مقدور عليه، لكن نُسدِّد ونقارب إلى الدرجة التي تكون فيها القراءة أقربَ ما يكون إلى الحياد، وأبعدَ ما يكون عن المقررات السابقة. إنَّ القراءة المحايدة قراءة تحب الحقيقة ولو أزعجتها، وتقبل الحق ولو كان من أبغض الناس، بل ولو كان من أفسق الناس، كما كان يقول أحد الكبار :
" إعمل بعلمي ولا يمنعك تقصيري ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري "
والقراءة المحايدة موضوعية، تحتكم إلى المعلومة التي تـنـقل الواقع كما هو، وتعرض الحقيقة كما ينبغي لا كما تحب .
وأخـيـراً القراءة المتسرعة
وأعني بها القراءة التي تأخذ موقفاً بادي الرأي، تخطف الكلمة أو الجملة خطفاً، ثم تبني عليه قصراً من وجهات النظر المتعجلة. ومن قرأ هذه القراءة فحتماً سينـقطع التواصل والتفاهم بينه وبين الكاتب، وسيحمل كلَّ ما يقرأ حملاً لا إنصاف فيه، وسيُوظِّف كلَّ ما يعرفه من آليات التعامل مع النصوص ليدعم وجهة نظره المتسرعة، فيشرع باصطياد الثغرات ـ أو ما يظن أنها ثغرات!! ـ ليُرديَ الكاتب أرضاً، ويحمل المحتمل على الصريح، وينادي على رؤوس الأشهاد ملوِّحاً بالمحتمل: أنْ هذا هو كاتبكم العظيم فاحذروه! ويقابل هذه القراءة، القراءة المتأنية المُنصفة، التي لا تستعجل النتائج، وتعطي الكاتب الفرصة التي يستحقها للفهم عنه، وتحمل محتمله على صريحة، وتستخدم آليات فهم النص لخدمة الوصول إلى الحقيقة.
وأخيراً، وتلخيصاً
إنَّ القراءة المطلوبة هي القراءة المبنية على الإخلاص والإنصاف والفهم والوعي والتدبر، القراءة التي تربط وتستنتج.
إن بداية النهضة هي قراءة صحيحة، ولا يمكن أن ينجح شعار الـتوحيد أولاً دون هذه القراءة. فلا عجب أن كانت هذه الكلمة أول كلمة في آخر رسالة. هذه الكلمة التي لا أجد في وصف عظمتها وخطورتها أبلغ مما قاله سيد رحمه الله فيها: "الكلمة التي أدهشت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثارت معه وعليه العالم". فلله درُّ سيد رحمة الله عليه. وكيف لا وهي التي وضعها القرآن بداية للذين حمَّلهم مسؤولية تغيير العالم، وقيادة البشرية، وقد سُئل فولتير مرةً عمَّن سيقود العالم، فأجاب: "الذين يعرفون كيف يقرؤون".
وها هي المطابع في العالم الإسلامي، تدفع في كل عام آلافاً من الكتب، وها هي الشواهد تدل على أن الذي يقود العالم هم الذين يحسنون القراءة، ونحن لا زلنا قابعين على حدود القراءة الأمية، العصافيرية، الخ.. القائمة القاتمة ! إننا نمتلك وسيلة الحضارة، ومنهج التقدم ؛ القرآن، ومع ذلك فإن حالة الوهن التي نعيشها تحرمنا من الإفادة من هذا الكتاب الحكيم.
إن حوارنا حوار طرشان، والتواصل فيما بيننا معدوم، ولقد يصدق علينا ما قاله حسن البنا رحمه الله: "إذا شرحت فكرتك لأحدهم عشرين مرة، ثم ظننت أنه قد فهمك فأنت متفائل"!
وأختم بهذا الحديث الرائع الذي يصف عجزنا عن القراءة المنتجة، وكيف أن القراءة المطلوبة ليست هي مجرد قراءة الأحرف، فقد روى زياد بن لبيد، فقال: " ذكرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلـم شيئاً، فقال: "وذاك عند ذهابِ العلم، قُلنا يا رسولَ الله : وكيف يذهبُ العلمُ؟ ونحنُ قرأنا القرآنَ ونُقرئه أبناءَنا، وأبناؤنا يُقرؤون أبناءهم، فقال: "ثَكِلتْكَ أمُّكَ يا ابنَ لبيد،إنْ كنتُ لأراكَ من أفـقهِ رجلٍ بالمدينة، أوَ ليس هذه اليهودُ والنصارى يقرءونَ التوراةَ والإنجيل، ولا ينتفعونَ ممَّا فيهما بشيءٍ؟!"، رواه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح.
______________________________
المصدر : مجلة العصر - الثقافة والأدب .